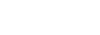أزمة نقد الشّعر العربي في ضوء النّقد المعاصر
دراسة نقديّة في ترويض اللّفظ بفلسفة المعنى
د. حسين الأقرع/ الجزائر.
الملخص:
تروم هذه الدّراسة إلى قراءة ثانية في فلسفة النّقد الشّعري العربي، وهي تُسلّط الضّوء على أهم الثّغرات النّقديّة الّتي شوّهت صورة النّقد لدى المتلقي وجعلت منه مطيّة لكلّ من أراد دون وجه حقّ؛ وهذا الاستسهال أفقد النّقد بريقه، وجعل النّتاج الأدبيّ بلا معنى؛ فخلق أزمة معرفيّة وفكريّة أدت إلى انحطاط الشّعر ونقده، وبدوره انعكس سلبا على الثّقافة العربيّة بالمجمل؛ لأنّ الشّاعر نبيّ في قومه، فكيف وكلّ القوم أنبياء بوهم الادعاء، ولو كان للنّقد الحقيقيّ صولته وجولته لعادت المياه إلى مجاريها، ولعرف كلّ منزلته، فمن العبث ترك السّاحة النّقديّة لغير أهلها، ولذا نحاول تحديد موطن الدّاء للخروج بتركيبة دوائية فعّالة عسى تكون سببا من أسباب نهضة نقد الشّعر العربي، وتعود به إلى ثورته وثروته، مع أنّ الأسباب عدّة ويحتاج العلاج مدّة، لأنّنا في الحقيقة تجاوزنا مرحلة الوقاية، والسّاحة شاهدة لفساد الذّوق وأعجميّة العرق.
الكلمات المفتاحيّة: دراسات نقديّة؛ نقد الشّعر؛ ترويض اللّفظ؛ فلسفة المعنى؛ نقد معاصر .
مقدّمة:
الدّراسات النّقديّة بحر ما له ساحل؛ وما الدّراسات الأدبيّة واللّغوية إلا جزءا منها، فهي تستند إلا كلّ العلوم والآداب، ولذا يجد الطالب صعوبة في فهمها رغم تدرج مراحل تدريسها؛ وهذا بسبب كثرة مجالاتها، وصعوبة رصد مآلاتها، وتنوّع قراءاتها، وكثرة مصطلحاتها، فيظن أنّها لا تقف على قرار، ويحتاج النّقد إلى نقد، وهو مع شبح النّقد الأوّل فكيف به مع غول الثّاني، وفي مجال الشّعر أشد؛ خاصة لمن جنح بخياله وأشكل بيانه، وقدّم وأخر وزاد وأنقص، فيصعب رصد المعنى لغريب المبنى، فيعسر تعلّمه فما بالك بنقده.
إشكالية البحث: ؟
/ ما الثغرات النّقدية التي أثرت سلبا على نقد الشّعر العربي؟
أهمية الدراسة:
/ رصد مواطن الوهن في النّقد الشّعريّ العربيّ .
/ تحديد الصّورة الحقيقيّة لمفهومي النّقد والنّاقد.
أهداف البحث:
/ العودة بالشّعر العربيّ إلى مكانته عند العربيّ.
/ تنقيّة النّقد العربيّ من الشوائب التي شوهت صورته.
/ صناعة ناقد حقيقي؛ جامعا مانعا.
أزمة نقد الشّعر من قصيدة النّثر:
وما زاد هذه الأزمة جَعْل الشّعر كبقيّة الأجناس الأدبيّة، والشّعريّةُ التي فيه لا تفتقدها الأجناس الأخرى!! وهذه النّظرة جاءت من الّذين لا يجيدون كتابة الشّعر العموديّ، فحاولوا خلق شعريّة وهميّة لقصيدة النّثر كما يسمّونها، ونحن هنا لا نطعن في أيّ جنس أدبيّ، وسنعترف به إذا أدهش، ولحدّ السّاعة قصائد النّثر المعروضة على السّاحة شوّهت الصّورة أكثر من تلميعها، وأجد الخاطرة التي يهرب منها ما يسمونهم بالنخبة وهي في نظرهم للمبتدئين في عالم الكتابة أكثر شعريّة وأكثر تماسكا من هذا الجنس الذي وُلد قبل اكتمال صورته، فجاء بتشوّهات لفظيّة ومعنويّة حاول أصحابها القيام بعمليات جراحيّة لها من خلال بحوث لا تستند لحجّة، وهي في أغلبها انعكاس لفكر أعجميّ لا يتوافق مع الذائقة والبلاغة العربيّة، وما يرفضه ذوق القارئ فهو منبوذ؛ والذّوق قوامه المتعة واللذّة، وهذا يأتي بعد انسجام واتساق متكامل للنّصّ الشّعريّ، وهذا ما تفتقده قصيدة النّثر. وحتّى من برع في العمودي وخاض غمار قصيدة النّثر للتّجريب لا أكثر يعرف الفجوة بين الجنسين، وما زاد الأزمة حدّة ما يسمى بالكذب التّاريخي و"الذي ظهر مع بروز المركزيّة الغربيّة وهو لا يهدف إلى إخفاء الحقائق بل إلى نقضها والحلول محلّها"[1]، ووصل هذا الفكر إلى شروحات قصائد النثر، فيقولونها ما لم تقل، ويريدون منّا الانبهار بفراغ!! لا أنكر أنّ لقصيدة النّثر رونقها الخاص في بيئتها ولغتها وأعمال شارل بودلير شاهدة، لكن البلاغة العربيّة أشرس في تقبّل مثل هذا اللّون، لأنّ المقارنة عبثية في حدّ ذاتها؛ فعندما يقول أدونيس: " أكثر الشّعراء في الغرب الذين كتبوا قصيدة النّثر كتبوا قبلها قصيدة الوزن، كانت قصيدة النّثر حدّا نهائيا لتجاربهم الشّعريّة، ولم تكن هربا فنّيا من الصّعوبة للسّهولة."[2] وهذا الرأي غيّر كثيرا النّظرة النّقديّة الصّارمة للشّعر العربي، فبناء الشّعر الأعجمي لا يقارن ببناء الشّعر العربيّ؛ لأنّ الشّعر العربيّ لا يقف على مسألة الوزن فقط، ولا يمكن لمن عرف العروض أن يبني بيتا شعريا إلا إن كان نظما بلا طعم ولا رائحة، أما عند الغرب فالميزان عندهم: كيف تكون شاعرا؟ وكأنّ هناك قالبا من اتبعه أبدع، وفي الشّعر العربي الميزان لا يُدركه العيان، وإن شئت أمامك أدوات البناء وتملك ناصية اللّغة ولكن لا يمكنك كتابة بيت شعريّ، فأين مكمن السرّ؟ فهناك شيء خفيّ قد يظهر بالتجريب والتّدريب إذا كان صاحب القصد يمتلك شيطانا في ذاته وأحاط بكثير من شعر غيره حفظا وإدراكا. وحقيقة الأمر لم يُخطئ "علي داخل فرج" عندما سمّاها بالخنثى؛ وهو عنوان كتابه: محاكمة الخنثى[3]، وبهذا الشكل الجديد خرج النّقد من عباءة الجليّ إلى الخفيّ، وجاءت قصة قراءة ما بين السطور لشيء لم يُكتب في الأصل.
وهم الادّعاء النّقدي:
هناك صنفان من النّقّاد لهما تأثير سلبي على نقد الشّعر وهما: النّاقد الذي لا يستطيع كتابة بيت شعري ويحاول إسقاط قوالب الأجناس الأخرى على الشّعر، والشّاعر الذي يُقحم نفسه في مجال النّقد بحكم أنّه شاعر!! وهو يجهل أبجديات النّقد ويفتقد روح النّاقد!! وهذان في الغالب تجد نقدهما يقتصر على رصد الأخطاء الإملائية والنّحوية والهنات العروضية! وهما لا يُدركان أنّ من أخطأ في شيء من هذا لا يُلتفت إليه في الأصل؛ وإلاّ لصار كلّ النّاس نقّادا.
خلل المناهج النّقديّة:
الذّائقة العربية وفلسفة النّقد الشّعري العربي لا يقومان على بناء قوالب نقديّة جاهزة؛ وهذا ما سارت عليه المناهج النّسقيّة الغربية كالبنيوية والأسلوبيّة والسّيميائية، وما أوقع نقد الشّعر العربي في مأزق، فإسقاطها على الشّعر العربي دون مراعاة خصوصيته جريمة في حقّه؛ لأنّ هذه المناهج تقوم على عملية إحصائية ترهق العمليّة النّقديّة ولا تخدمها، زيادة فوق هذا فهي تهتم بالبنية الشّكلية للنّص وتلغي كل ما له علاقة به من مؤلف وسياقات خارجية ساهمت في بناء النّص، وحتى المناهج السّياقية كالتاريخي والاجتماعي والنفسي وغيرها والتي عالجت النّص من خلال سياقاته الخارجيّة لم تخدم النّقد بالشّكل المطلوب وتركت مجال التّأويل أوسع من الحقيقة فأبعدت النّقد عن العلمية المرجوّة، ورغم ذلك أرى عبثيّة التّعليم في عدم التّركيز على المناهج السياقيّة في تحليل النّصوص الشّعرية فهي أقرب لبناء شخصية نقدية عربية متوازنة؛ لأنها تهتم بعدة ميادين معرفية وهذا ما يصعب على الطالب إدراكه.
النّفاق النّقدي:
يظهر النّفاق النّقدي في مجالين وهما: المسابقات الشّعريّة الوطنيّة والدّوليّة وفي الدّراسات الأكاديميّة!! فتجد قصائد فاقدة للشّعريّة تحصّل أصحابها على جوائز ليس من حقّهم بسبب تدخل السّياسة، أو اسم ومكانة صاحب القصيدة أو رسما لجهوية مقيتة وحقد دفين! فيظن الجمهور أنها الأفضل والأحسن على حساب عيون الشّعر فتستفحل الرّداءة، وفي مجال الدّراسات الأكاديمية وخاصة في مذكرات الماستر ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة والمقالات العلميّة يُعتمد الديوان أو القصيدة حسب اسم الشخص ومكانته الاجتماعية أو السياسية!! وبهذا يتم طمس الشّعر الحقيقي وتتبلّد الأذواق، والأخطر من ذلك التودّد إلى الشّاعرات ومنحهنّ ألقابا ليس من حقّهنّ. والأخطر من هذا كلّه هناك رؤية متطّرّفة ترى أنّ كلّ شعر عمودي موزون مقفى مُقلّد مسروق ولا يصلح للدّراسة ويجب الالتفات للشّعر الحداثي الذي يرمي بكل هذه القيود خارج دائرة الإبداع!
جنس الرّواية:
ما أرهق نقد الشّعر في عالمنا المعاصر هو مبالغة الاهتمام بجنس الرّواية على حساب الشّعر من صنّاع القصيد! لحركة أدبية عالمية غير بريئة جعلت لسان الضاد بالمجمل في حيّز الاتهام والاحتقار، والشّعر بدرجة أكبر! وهذا التّوجه جعل الشّعراء أنفسهم ينظرون إلى أنّ الرّواية أكثر شعبيّة وعالميّة، وأنّ لكلّ عصر جنسه! فبدأ يخوضون في عالمها دون موهبة ففسد الشّعر وفسدت الرّواية.
النّاقد قارئ غير عاديّ:
النّاقد لا يقرأ كما يقرأ العامة، فهو يستحضر تفاصيل الكتابة وكأنّه هو المؤلّف، وهذا النّوع غائب في المجمل بما عسّر وجود نظريّة نقديّة شعريّة عربية؛ والأسباب كثيرة ومنها:
/ الدراسات النّقدية دخلها من لا أهل لها بحكم أن امتحانات المسابقة لا تعكس الرّوح النّقديّة الحقيقية، وهي في الغالب مباشرة لا تفجّر القاموس النّقديّ للممتحن، ومهما يجتهد الطالب بعد ذلك يأتي النص النّقدي باهتا لغياب الموهبة.
/ من تصدّر المشهد النّقدي أغلبهم لا يستطيعون بناء بيت شعري، فالنّاقد الحقيقي لابد أن يقدّم بديلا عند نقد عمل ما، وإن لم يكن النّاقد شاعرا أنصحه بالاهتمام بجنس أدبيّ آخر.
/ البحث عن لغة ثانية! وكأنّ العربية قاصرة عن بلوغ المرام! فيجد النّاقد نفسه في بيئة وفلسفة بعيدة عن حياة اللغة العربية.
/ محاولة لَيّ عنق النّص وتأويله فوق احتماله؛ لِيُقال: ما أبعد نظره! وهو بهذا قتل النّصّ وقتل نقده.
كثرة المصطلحات:
تعدّد المصطلحات أحدثت فوضى نقديّة وجعلت النّاقد الحقيقي يختفي أمام هرطقة شبه النّقّاد بمصطلحات ما قدّمت شيئا للنّص سوى الصّعود به نحو الأسفل! والأكيد أن تعدّد المصطلح العربي أربك النّقّاد فما بالك بالمصطلحات الأجنبيّة التي حوّلتها التّرجمة إلى حقل ألغاز، فمفهوم مصطلح واحد تجده بعد التّرجمة بمفاهيم عدّة! وهذا ينتج عنه قراءات نقدية عدّة وبروز مصطلحات جديدة، النّقد في غنى عنها.
عبثية التّرجمة:
عندما يتقدّم للتّرجمة من لا يُتقن التّرجمة العكسيّة هنا تكون الكارثة؛ بمعنى أنّه ينقل المعارف من لغة أجنبية إلى العربية بحكم أنّه عربيّ وهذا من خلال المعنى العام أو الاستعانة ببرامج التّرجمة، ولا يستطيع ترجمة نص عربي إلى لغة أجنبيّة أخرى وهو يقوم بترجمة اللغة الأخرى إلى العربيّة بحكم أنّه لا يملك الأدوات اللاّزمة للّترجمة، وهذا ما وقع مع ترجمة أغلب المناهج النّقديّة والمصطلحات الغربيّة وإسقاطها دون نقدها على ميزان اللغة العربيّة فأحدثت فوضى النّقد وخرجنا بمسخ شوّه العمليّة النّقديّة، والمصيبة أنّ هذا المسخ مستمرّ دون توّقّف بحجة البحث عن نظريّة نقدّية عربيّة، ومشكلة البحث تكمن في اعتماد نفس الطّرق والمناهج التي أثبتت فشلها، بل الفشل الأكبر تكليف نفس الأشخاص بمهمة البحث من خلال مخابر البحث في الجامعات أو مجالس اللغة العربية المعتمدة في أغلب الدّول العربيّة.
الحكم الآني:
القصيدة تحتاج إلى قراءات وفي أوقات مختلفة قبل الحكم؛ فقد تكون القصيدة في غرض الرّثاء والنّاقد في وقت فرح فيرى القصيدة أسوأ ما كُتب! وقد يكون في مزاج متقلب لا يقف على قرار فيظلم صاحب النّص، وقد تكون بها بعض الألفاظ أو المعاني التي تعسّر فهمها من طرف النّاقد فيرمي الشعر والشاعر بالنّقص والضحالة!
المتطفّلون على الشّعر:
القارئ للشّعر العربي الحديث والمعاصر يجد في أغلبه فجوةً عميقةً تفتقد إلى الشّعريّة؛ فلا لذّة ولا صورا ولا تركيبا! والمصيبة تجد الشّاعر يكرّر نفس المعنى في أغلب الأبيات مع تنوّع اللّفظ، وهذا اللّعبُ لَعب بفلسفة أغلب نُقّاد المسابقات الشّعريّة، والمصيبة الأكبر أنّ الشّاعر حسب مفهوم العامة يكتب قصيدة هو في حدّ ذاته لا يفهم معانيها! فيبدأ التّنطّع من أشباه النّقّاد في محاولة تأويل النّص الغامض حتى على صاحبه وهو ما يزهق روح النّقد
جهل البلاغة العربيّة:
فن الكلام يحتاج إلى بلاغة وخاصة الشّعر، والنّاقد المعاصر يسير في درب لا تقبله الذائقة العربية على العموم، فهو من جهة متأثر بالبلاغة الغربية التي تظهر بمظهر المسخ أمام البلاغة العربية! ومن جهة أخرى اهتمامه بالصور المتناقضة والتي يمقتها الشّعر العربي الأصيل، فإغراق النّصّ الشّعري باستعارات تصوّريّة خالية من الزخرفة اللفظية جريمة في حق النّصّ الشّعري، حتى ظهرت قصائد لكبار النّقّاد خاصة في العالم العربي هي بدايات المبتدئين؛ لأنّ التأثر بالشّعر الغربي والثقافة الغربية أخذ منهم كلّ جميل، والذائقة العربية تشمئز لدخول هكذا أفكار.
الفراغ من الزاد الأدبي:
يسبق النّقد الأدب، وهذا من البديهة، ولكن من العجيب أن يتصدّر للنّقد من يفتقد لقاعدة معرفيّة أدبيّة، فتجد الطالب في سنة التّخرّج وهو لا يحفظ بيتا، ولا يفقه صوتا، ولا في رصيده أسماء أشهر النّقّاد في بلده فما بالك بمن هم خارجها، والذنب ذنب أستاذه؛ ففاقد الشّيء لا يعطيه، وأهم مادة تمّ العبث بها هي مادة المحفوظات! فوجب على الطالب حفظ ما تيسّر من الأشعار وسير أعلامها، ويمتحن فيها فإن أفلح انتقل وإلا رسب، فخاصيّة الحفظ ملزمة في مثل هذه المقياس، فلا يستطيع أن يصل الطالب إلى بناء فكري سليم وهو فارغ الرّأس، فما بالك بالتّفكير النّقديّ.
المال والإعلام:
المال الفاسد والإعلام الضال المضلّل من أسباب نكسة النّقد، فكم من دواوين شعريّة مُوّلت وطُبعت ورُوّجت باسم الأدب لأناس يريدون بصمة في الحياة ولو بالرداءة! وصمت النّاقد كان جريمة في حقّ الإنسانية، فهذا الصّمت ورّث القيم الضّارة لا الحضارة، وصار كلّ من يصدح بالحقّ يواجه بالمال والإعلام، والأخطر من ذلك دخول المال والإعلام البحوث الأكاديمية، فلا تهم قيمة البحث إن تدفع أكثر، وسنذيع صوتك إن كنت ذا مال وجمال! فما رفع الأدب بعد هذا راية، وما حقّق النّقد غاية.
الاتّهام الباطل:
يحكم كثير من النّقّاد المعاصرين على شعراء الإحياء بالتّقليد، بمعنى آخر بالوقوع في السّرقات، ودليلهم اعتماد البحور الخليليّة! والتّقريريّة في التّعبير حسب زعمهم! وللخروج من هذا المأزق يجب على الشّاعر أن يأتي بالجديد! وجديدهم في خلق صور غامضة متكرّرة يصعب فكّ طلاسمها! وكلّما أوغل الشّاعر في الغموض كلّما حسن مقاله وصار من فحول الشّعراء! وبهذا المسلك وقع الشّعر في فخّ الرّداءة، وهم يعلمون أن الجمهور من النّاس يميلون إلى الوضوح مع استعمال بعض صور البيان والبديع، وأنّ النّاس من يخلدون الشّعر بذكره وذكر صاحبه، فهل رأيتم إماما على المنبر يتناول أبياتا لشاعر حداثي؟ ونحن نعلم حقيقة البناء للشّعر المتأثّر بالشّعر الغربيّ؛ فلا تكاد تجد جملة مفيدة، وإذا سألت عن الموسيقى يقولون لك: هي داخليّة وليست كالشّعر العربي الأصيل خارجيّة! ويقولون: على القارئ قراءة ما بين السّطور! وتقديم كلّ شيء يعلّمه الكسل والتّواكل! وبهذا سار النّقد على طريق الانحراف.
مفهوم النّقد:
رغم أنّ أغلب مفاهيم النّقد تصبّ في هذا المعنى بقولهم: " هو أحد الفنون الأدبيّة الذي يهدف إلى دراسة الأثر الأدبي أو الفني، وتفسيره وتحليله وموازنته بغيره المشابه له، أو المقابل، ثم الحكم عليه، ببيان قيمته ودرجته، أي تقويم هذا الأثر."[4] لكن في نقد الشّعر تتجاوز الدراسة دراسة الأثر الأدبي والفنّي إلى علوم أخرى كالعلوم الاجتماعية والطبيعية وحتى الدّقيقة منها، ومن درس البحور الشعرية والدوائر العروضية بشكل خاص سيكتشف عبقرية الفراهيدي في بناء الهندسة الرياضية لهذا العلم؛ ألا وهو علم العروض.
وقبل الخوض في فلسفة البيت الشّعري لابد أن يقف الشّاعر على ملامح الشّكل الخارجي للبيت ومنها اختيار الوزن، فلو وضعت مثلا قول الشّاعر: (بحر الكامل).
لِأَقُـــــــول: رَوْحٌ لِــلــنَّـبـيِّ ورُوحُــــــهُ
***
مَـنْ فِي النِّسَاءِ كَزَهْرَةِ الصِّدِّيقِ؟
فِـــي كَــامِـلِ الأَوْزَانِ صُـغْـتُ كَـمَـالَهَا
***
(مُـتَفَاعِلُنْ)؛ كَـيْ تَسْتَبِينَ طَرِيقِي[5]
فالملاحظ أن البيتين من بحر الكامل؛ وتفعيلاته: مُـتَفَاعِلُنْ مُـتَفَاعِلُنْ مُـتَفَاعِلُنْ؛ تتكرّر ثلاث مرات في الصّدر وثلاث مرات في العجز. والغالب أن تفعيلة (مُـتَفَاعِلُنْ) هي أصل التفعيلات، فبقلبها ودخول الزّحافات والعلل نتحصّل على جميع تفعيلات البحور الأخرى، وفوق هذا فبحر الكامل هو حِمَار الشّعراء في العصر الحديث لسهولة الكتابة عليه وأنه يستقطب جميع المواضيع والأغراض بسهولة؛ لأنّه يمثل الكمال في الشّكل والمعنى، وأيّ شاعر يُدرك هذه الحقيقة، فالشّاعر الحقيقيّ الكلام عنده من يفرض الوزن وليس العكس، وبالعملية العكسية فقد الشّعر بريقه بسبب فرض الوزن على الكلام فجاء الشّعر ركيكا، حتى ولو كان الشّاعر بارعا سيدرك القارئ بعد تكرار القراءة أن هناك فجوة حتى ولو عجزت اللّغة عن ترجمة مشاعره.
وللأسف فأكثر أهل النّقد يحصرون النّقد في التّحليل والتّفسير والتّقييم وتمّ إهمال أهم خاصيّة في النّقد ألا وهي التّقويم الذي يفصل أهل الدّراية عن أهل الادعاء، فالنّاقد الحقيقي يفصل بين الرّؤيا والرّؤية في مرحلة التّقويم، وامتلاك الرّؤيا تجعله يشعر بالخلل الذي يعتري النّصّ من أوّل قراءة، كما لو أنّه يتذوّق طعاما؛ فهذه السّرعة في الإدراك تأتي من خلال ممارسة العملية النّقديّة أثناء القراءة وليس أثناء العمليّة التّعليمية، ولهذا نقول للطّالب: أصعب شيء في اللغة هو الأسلوب، والذي لا يستطيع أن يمتلكه كلّ متعلّم والذي يستطيع أن يملك بعض الطلبة ناصيته بعد التّفرغ للكتابة لا إلى النّحو والصّرف والبلاغة؛ لأنّ كلّ هذا يأتي بعد ممارسة الكتابة، بل ويكون الطّالب أكثر تحكما من غيره في اللغة، للذين جعلوا تعلّم النّحو والصّرف والبلاغة أولوية عن تعلّم فنّ الكتابة.
قد يقول قائل: أليس تعلّم فنّ الكتابة من الفنون البلاغية؟ فأقول له: هو جزء منها، ولكن أن تتعلّمها من خلال تأليف لك ويقوّمك أستاذك ويستبدل كلاما بكلام أحسن من أن تتعلّمه من تأليف غيرك، فالتّجربة أثبتت ذلك.
فتعلّم الأسلوب يخلق ناقدا فريدا من نوعه، وليس كثرة الكتابة دليل التّميّز، وهذا ما سارت عليه أغلب لجان التّحكيم؛ الأولوية لأكثرهم تأليفا في النّقد وليس أبرعهم أسلوبا! وقد تجد من يملك كتابا واحدا أكثر فهما وأعمق في أفكاره وأبرع في أسلوبه من الذي يملك عشرات الكتب.
ومن المزالق الّتي وقع فيها النّقد في وحل الرّكاكة هو غياب التّجريب، فلو تمّ إنشاء ورشات خاصّة بتجريب النّقد على نصوص مختلفة وتجمع بين الارتجال والبديهة والروّيّة لخرجنا بنقّاد أفذاذ.
مفهوم النّاقد:
لا يدرك فلسفة النّاقد من تعوّد على مباشرة وثرثرة الكلام، فالنّاقد محبّ للاختزال، دقيق المقال بعيد المنال، ينظر بأعين الجماعة رغم أنه فرد، فعند سماعه كأنّك أمام عالم اجتماع وفي نفس الوقت تاريخي ورياضي وفيزيائي و ... ويجعل كل هذا الاختلاف في عقد واحد فيظهر لك كأنّه من معدن واحد.
النّاقد الحقيقي هو الّذي له القدرة على قراءة الشّفاه والأعين قبل قراءة الكلمات سواء مباشرة أو من خلال التّسجيل، وأنّ له القدرة على تمييز الجيّد من الرديء من خلال قراءة بيت المطلع وبيت المخرج، وقد يعتمد خاصية المسح من خلال قراءة سريعة لجميع أبيات القصيدة مع التّركيز على البداية والنّهاية.
حقيقة يستفزني النّاقد الذي يقرأ قصيدة لشاعر ما فيحكم عليها بالضّعف، وحجّته أنّها مليئة بالأخطاء النّحويّة والإملائية! يا هذا .. ! إنّ الخطأ النّحويّ والإملائي قد يصحّحه أبسط قارئ، ولكن الأسلوب قد يجهله من اعتكف على الكتب منذ صغره، وكان على النّاقد أن يقول: القصيدة جيدة في مبناها ولكت تتخللها أخطاء نحوية وإملائية شوّهت النّصّ، ويقوم بتحديد مواطن القوّة ومواطن الضّعف مع إعطاء البديل.
قد أطلب في بعض الأحيان من النّاقد أن يُغمض عينه ويُركز بسمعه على النّص من خلال تسجيل القصيدة بصوته أو أن يطلب من قارئ قراءتها؛ لأنّي أشعر كأنّ النّظر يُحيد بالنّاقد عن الموضوعيّة، وهذا يقودني إلى العمليّة العكسيّة في تأليف النّصّ، فأغلب فاقدي البصر من الشّعراء أبرع من غيرهم في بناء القصيدة.
النّاقد من يستشهد أثناء نقده بما هو من جنس النّصّ ولغته، فكيف أن ينقد قصيدة عربيّة ويُسقط أقوال نقّاد أو شعراء غربيين على النّصّ! فالبلاغة غير البلاغة، وكأنّه يعالج إنسانا بدواء بيطري!
فلسفة التّرويض:
التّرويض الفكريّ العربيّ النّقدي يمرُّ عَبر قناة الحفظ قبل أيّ قناة أخرى، ومن لم يتقن هذه الخاصيّة فهو فاقد لأهمّ عنصر من عناصر التفكير النّقديّ، فالدّماغ يبحث عن رصيد معرفي شعريّ ضخم، فبعد التّخزين الممنهج يأتي التّكرار؛ وهو إعادة ما تمّ حفظه لتثبيت المحفوظ، ويجب اختيار أوقات الحفظ والتّكرار، فالحفظ مثلا أوقاته تبدأ من قبل صلاة الفجر بساعة أو أكثر إلى منتصف النّهار، والتّكرار اختر له أيّ وقت؛ المهم أن يكون الدّماغ في راحة، وبعد التّكرار يأتي التّطريب أو التّلحين لما تمّ حفظه، فالتطريب يحفظ ما تمّ حفظه، فالغناء للشّعر من أهم عادات الشّعراء قديما، وهو مضمارهم في بناء القصيدة.
فبعد ثلاثية الحفظ والتّكرار والتطريب يأتي التّدريب؛ والتّدريب هو القدرة على تقليد ما تمّ حفظه وتكراره وتطريبه، وهنا نأتي إلى أهم خاصية من خصائص النّاقد ألا وهي القدرة على قرض الشعر، فالنّاقد الذي يعجز عن بناء بيت شعري لا يحقّ له نقد الشّعر، فللشّعر أسراره ولن يكشفها المتذوّق لها إن لم يكن من صنّاعه.
بعد هذه الومضة التي تمثل الباب الأوّل للنّاقد يأتي التفكير النّاقد للقصيدة والذي يتجاوز حدوده المعرفة بعلوم اللغة العربيّة إلى العلوم الأخرى بجميع أنواعها لتصل ثقافة وتقاليد المجتمع، كل هذا من أجل بلوغ مرحلة التفكير النّاقد الحقيقية ألا وهي قوّة الحدس والفِراسة، وقوة الحدس والفراسة يأتيان بممارسة الأدب والعلوم الأخرى وليس بالتّعلّم فقط؛ فالممارسة أن تُحوّل الجماد إلى الحياة، فتصبح اللغة لها حواس كحواس الإنسان، فعند قراءة أي نصّ يتلذذ النّاقد به كتلذّذه بأي طعام، هذا عند قراءته الأولى، والقراءة الثانية تكون مختلفة بتوزيع أجزاء النّصّ وكأنه يبحث عن مكونات هذا الطّعام.
والدّارس لمعادن النّقّاد يرى بأنهم يبحثون عن مخرج لكلّ منتقَد حتى لا يُظلم الشّاعر، وهذا يحتاج لرويّة وعلم عزير، فالبحث عن مخرج بالدرجة الأولى يجعله يتقمّص شخصيّة الشّاعر؛ وكأنّه هو صاحب القصيدة.
للأسف كثير من أهل الأدب يحسبون أن كثرة المطالعة هي مفتاح النّقد مع أنّ المطالعة دون فقه مرهقة للتّفكير النّقدي، فمحاولة تفكيك المعنى ولو بالشيء اليسير يخلق لدى القارئ عينا ثالثة.
لعلّ أكبر النّكسات التي عرفها النّقد أن يقول النّاقد لصاحب القصيدة: قصيدتك تحتاج إلى معجم لمعرفة ألفاظها؟! وكأنّ الشّاعر نسج نصّه بلغة الجنّ! ولو بحثنا في القصيدة لوجدنا بعض الكلمات الغريبة عن النّاقد، ولو اجتهد في معرفتها لكانت زادا له، مع العلم أن الغريب عند شخص قد يكون مشاعا عند آخر.
إنّ فلسفة التّرويض تحتاج إلى صبر ومجاهدة، وقد يسلخ الإنسان عمرا حتى يصل إلى شبه ناقد، لأنّ الحديث عن ناقد كامل الأوصاف وَهْم في حقيقته، وما يشاع هنا وهناك عن ناقد موسوعيّ سوى إشهار مقيت، ولو واجهت الممدوح لرأيت حجم الكارثة التي هو فيها، ونحن لا نتحدّث عن أصحاب التّخصّص الدّقيق، بل حديثنا عن ناقد للشّعر. والنّاقد للشّعر يجب أن يقطف من كلّ روض زهورا وليس زهرة.
تنوّع المعارف يصنع ذوقا للقارئ، ولابد للقارئ أن يُنمّي ذوقه، وتنمية الذّوق تأتي من خلال الاحتكاك بأهل الرّأي في جميع العلوم، ومن الصّعب تنمية الذّوق دون عشق الشيء، فالحبّ يصنع المعجزات، ولا يمكن أن تحدّثني عن ناقد وهو يكره الشّعر، بأن أقول أكثر من ذلك: أن يكره عِلْما من العلوم وهو يعلم علم اليقين أن النّقد يحتاجه، إلا أن يكون جاهلا بالشّيء وهذا ليس بناقد.
قد دعا الباحث " عثمان مُوَافىَ في كتابه: دراسات في النّقد العربي" إلى الاستضاءة بقواعد ونظريات النقد الأوروبي بقوله: " لا ينبغي أن يُفهم من مناداتنا بأن يقوم الدّرس النّقدي على أصول النّقد العربي، أن نضرب صفحا عن النّقد الأوربي، ونسقطه من حسابنا ولكن على العكس من هذا التّصوّر."[6] وأنا قد أوافقه في الأجناس الأدبيّة الأخرى، ولكن في مجال الشّعر لا؛ لأنّ الشّعر العربي له خصوصيّة في التأليف والنّقد، وإسقاط أيّ معرفة أجنبيّة لتحليله تقتله، فطبيعة الشّعر العربي عصيّة عن التّرجمة في حدّ ذاتها بكيف بآليات وتقنيات أجنبيّة أن تفسّره، وللأسف من خلال اعتماد هذا المبدأ ضاع النّقد والنّاقد، وركبنا موجة أغرقت الجميع؛ المؤلّلف والقارئ والنّاقد، حتى صار يقول الشّعراء: ما فائدة طبع الدّواوين الشّعرية والقارئ مفقود؟ والحقيقة أنّ القارئ موجود ويُطالع كلّ صغيرة وكبيرة ولكنّه يبحث عن ضالته، فالمرشد يحتاج لمرشد، فالّذين يقودون السّفينة سيغرقونها، ونتيجة هذا التّوجّه ظاهرة للعيان، وكما يقولون: العبرة بالنّتائج، ونتيجة التّعليم الخاطئ لمقاييس النّقد بصفة عامة والشّعر العربي بصفة خاصّة أفرزت عاهات نقّديّة ترى رأيها هو الصّواب، ومن يُخالفهم مجرد غوغاء وهذا هو الدّاء.
ولو بحثنا في أخطر الأمور التّي حَادَت بالنّقد عن صوابه هو " قلة الدّراسات والبحوث حول تعليميّة النّقد"[7] وهذا أهمّ عمل يقود إلى فلسفة التّرويض؛ فتعليميّة النّقد الأدبي عصارة تجارب وليس اطلاعا كبقيّة المقاييس، ومن فشل في هذه التّجارب سيصمت وسيكتب إلا من مسك الشّعر من ناصيته، ولهذا لو طلبت من الّذين يحملون شهادات في الدّراسات النّقديّة بكتابة مقالات في ميدان تعليميّة النّقد الأدبيّ الشّعري سترى حجم الكارثة، ولهذا أدعو الوزارة إلى تعيين مفتّشين يراقبون العمليّة التّعليميّة للنّقد في الجامعات، فهو أساس المعرفة، ونفور الطلبة من النّقد بسبب جهل المدرّس له، وكما قيل: فاقد الشّيء لا يُعطيه.
الخاتمة:
اللغة العربيّة بصفة عامّة مستهدفة، فما بالك بالنّقد، وما دام الشّعر ديوان العرب تقوم بعض دوائر السّوء بتشويهه، وبداية تحطيم اللغة بدأت من المراحل الابتدائية للتّعليم، فتجد التّلميذ يدرس خمس سنوات وكأنّه ما دخل المدرسة! حتّى القصائد الّتي تمّ اختيارها للكتب المدرسية هزيلة وضعيفة في معناها ومبناها وفيها من الأخطاء الشيء الكثير، وقد يعتقد بعض الدّارسين أنّ الحديث عن التّعليم الابتدائي لا علاقة له بنقد الشّعر! ولا أعرف كيف يفكّر هؤلاء، وقد كنّا نحفظ وننشد أنفس القصائد، وبها كوّنّا ثروة لغوية، وبها نتقن التّعبير والإملاء، وبها ندافع الآن عن لغتنا، وهذا الجيل لا يستطيع بناء جملة مفيدة! فكيف تريده أن يدافع عن لغته! فإن فسد الأساس فسد كلّ شيء، وعشق الشيء أكبر حافز فما بالك لو قُتل هذا العشق من الصّغر.
والحقّ المرّ أن يتمّ توجيه أضعف الطّلبة إلى ميدان العلوم الإنسانية واللّغة العربيّة بشكل خاص! حتى صار المجتمع ينظر إلى اللغة العربيّة بعين النّقص، بل تجاوز النّظر إلى الكلام والاستهزاء باللغة العربيّة وبالطّالب الّذي توجّه هذا التّوجّه! فإذا كان المجتمع ينظر إلى اللّغة الأمّ بهذه النّظرة فكيف يكون حال النّقد؟!.
للأسف إنّنا نسير عكس التيّار النّقدي الذّي كان يجب أن نسير معه، فالطّالب يبدأ بالأدب ثم اللّغّة حتّى يصل إلى النّقد، ولكنّ الملاحظ أنّ الطّالب يحصل على الشّهادة ورصيده الأدبيّ قريب من الصّفر، وما يتعلّق باللّغة أميل إلى ممارستها من خلال تكثيف الأعمال التطبيقية وإرغام الطالب على التّأليف من خلال فتح ورشات واستدعاء المؤلفين والأكاديميين المتمكنين، ولا مجال للحديث عن رأي فلان أو فلان، فالعمل يخضع للإبداع والابتكار، فما أرهقنا إلى الجانب النظري المتضارب المتناقض في مفاهيمه.
زيادة فوق هذا يجب إنشاء مخابر تهتمّ بالنّقد عامّة والشّعر العربيّ خاصّة، ولن يوجّه لها إلاّ من أثبت تفرده من خلال أعمال منجزة مسبقا، تخضع لتحكيم صارم، وأن يكون صاحب المنجز كثير التأليف دقيق المعلومة، لبيب أريب؛ لأنّ سبب دمار مخابر البحث أن تُرسل إليها حديث البحث قليل التّجربة فاقد للأدب واللّغة، وحتّى من يملك اللّغة وهو يفتقد الأدب لا يصلح لمخبر البحث.
إنّ من مزالق النّقد الموجودة في الجامعات العربيّة مُطالبة الأستاذ بإتقان لغات أجنبيّة وعلى رأسها اللّغة الإنجليزيّة، ومع نقد الشّعر العربي لو كان الأستاذ يُتقن لغات أهل الأرض قاطبة لن يُفلح في نقد الشّعر؛ وهذا ما حدث لكثير من العباقرة وخاصة في الجزائر لو أخذنا على سبيل المثال مجال الطّبّ؛ فيتحصّل الطّالب على معدّل ممتاز وتكون رغبته أن يكون طبيبا، فيجد اللّغة الفرنسية عائقا أمام تقدّمه؛ لأنّ تدريس الطبّ في بلادنا باللّغة الفرنسية! فتضيع كثير من الكفاءات بسبب شيء تافه، ولو تمّ تخصيص بعض المنح الجامعية لهؤلاء الطلبة وإرسالهم إلى جامعات تُدرّس الطّبَّ بالعربيّة ما ضاع النّوابغ.
يجب أن يكون الشّعر قبل نقده أسلوب حياة للإنسان العربيّ المعاصر، وبه الحيَاة والموت، يتنفّسه كما يتنفّس الأكسجين، يتلذّذ القصائد كتلذّذه للأطعمه، فهذا هو أسلوب الحياة الّذي مرّ به العربيّ قديما، وخلّد مآثره.
واقع الأمر يدعو للبكاء؛ تُر سل قصيدة هجاء لأحدهم وتذكر مساوئه ومساوئ أهل الأرض وتُسقطها عليه فيضحك! ماتت فيه النّخوة قبل أن تموت اللّغة، فهل بمثل هذا يحيا النّقد! والوباء منتشر لأنّ أمثاله في كلّ مفصل من مفاصل صناعة القرار، فمات المريض والطّبيب، بل سيموت الّطبيب قبل المريض!.
قد يتهمني بعض النّاس بالجنون حين أقول: يجب نشر الأدب واللّغة والنّقد في الشّارع من خلال وضع جداريات بها أشهر وأحسن ما قيل! لأنّ القرارات السّيادية والجامعات تأثرت بما يفرزه الشّارع، وصار هو الفيصل في الخفض والرّفع، ويفرح الوليّ بإتقان ابنه لغة أجنبيّة ولا يحزن لتعثّره في لغته الأمّ! ومن هنا تسقط الحضارة! ويأتي الاستدمار الثقافي، ويتم صناعة العملاء والخائنين للوطن والدّين! وواقع الأمّة العربيّة لأكبر دليل على ذلك، فتجد أهل الرّأي يدخلون بعض الكلمات الأجنبيّة في كلامهم ظنّا منهم أنه صنع لهم تاجا ويقول النّاس أنّهم مثقّفون! وهل هناك زعزعة للأمّة العربيّة أكبر من هذه الزّعزعة؟
نقد الشّعر العربيّ يموت موت الغريق! وما زاد الأزمة أزمة هو التّنديد كواقع العربيّ في كلّ أزمة! ولن يرى النّقد النّور إن لم يَرَ كلّ صاحب قلم نفسه أُمّة، ولا ينتظر ما يفعله غيره، فالتّغيير يبدأ بالنّفس ثم ينتقل إلى الجماعة، ليصنع من نفسه مدرسة لا سجنا، وأن يبني معارفه على الأصل لا الفرع، ثم تأتي مرحلة الفرع بعد ذلك.
مهما يكن لن يفقد الشّعر العربيّ بريقه وسيبقى كشمس الضّحى وهو خالد خلود الإنسان، وينتظر أهل الوفاء من أهل اللّغة لإرشاد الضّالين من أهل البحث والتّنقيب إلى أصل النّور، ليعلم العربّي حجم هذا الكنز المخفيّ، وأن يرمي الضّوضاء الّتي تلاحقه في كلّ رُكن معرفي.
هوامش:
[1] ـ زكيّة عرعار، الخطاب النّقدي ما بعد الكولونيالي عند مصطفى الأشرف، دار كنوز المعرفة، ط1، الأردن، عمان، 2022، ص 193.
[2] ـ أدونيس، علي أحمد سعيد إسبر، في قصيدة النّثر، مجلّة شعر، عدد 14، 01 أفريل 1960، بيروت، ص 79.
[3] ـ ينظر علي داخل فرج، محاكمة الخنثى، قصيدة النّثر في الخطاب النّقدي العراقي، دار الفراهيدي،ط1، بغداد، 2011.
[4] ـ منيف موسى، في الشعر والنقد، دار الفكر اللبناني، ط1، بيروت، لبنان، 1985، ص 45.
[5] ـ حسين الأقرع، قصيدة بعنوان: رزان مكّة، الديوان، تم الاطلاع بتاريخ: 17/04/2024، الرابط:
https://www.aldiwan.net/poem115991.html
[6] ـ عثمان مُوافَى، دراسات في النّقد العربي، دار المعرفة الجامعيّة، (د.ط)، الإسكندريّة، 2000، ص 20.
[7] ـ نبيلة آيت علي، تعليميّة النّقد الأدبي في الجامعة، مجلة الأثر، مجلد 14، عدد 23، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ديسمبر 2015، ص 67.
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »