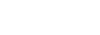فنيات القصة الأدبية
فنيات القصة الأدبية
فنيات القصة الأدبية
القصة وتوابعها
د. ريمه عبد الإله الخاني
مدخل
القصة سرد واقعي أو خيالي لأفعال قد يكون نثرا أو شعرا يقصد به إثارة الاهتمام والإمتاع أو تثقيف السامعين أو القراء.
ويقول (روبرت لويس ستيفنسون) - وهو من رواد القصص المرموقين:
ليس هناك إلا ثلاثة طرق لكتابة القصة:
فقد يأخذ الكاتب حبكة ثم يجعل الشخصيات ملائمة لها.
أو يأخذ شخصية ويختار الأحداث والمواقف التي تنمي تلك الشخصية.
أو قد يأخذ جوًا معينًا ويجعل الفعل والأشخاص تعبر عنه أو تجسده..
تبقى للقصة خصوصيتها ولمعانها الخاص بعيدا عن الرواية، وكتابتها لاتقل صعوبة عن أي نوع أدبي آخر، وقد انتهجت القصة حديثا النهايات المفتوحة عموما، وهذه تتطلب مقدرة على إعادة صياغة الحديث، بطريقة مثيرة وجاذبة للقارئ، ومليئة بعناصر التشويق:
فكرة، ولغة وحبكة ونسقا، وعليه فللوصول لكتابة قصة مميزة او ناجحة ، تحتاج صبرا وفوق كل شيء عين ناقدة واقعا وأدبا، دون تجريح ولا إسفاف يتجاوز المعقول.
هذا المقرر يتبع ماورد في الفصل الأول منه، في أنه يدخل من العموم إلى الخصوص. فنقسم مقررنا إلى قسم نظري وقسم تطبيقي للأهمية، وعليه فلن تكون محاضراتنا عن القصة وفيرة بقدر تغذية الجانب العملي منها، فالدارس إن لم يتقن فن القصة كتابة وممارسة ، فلن يستطع فهم ومعرفة أسرارها حق المعرفة، وهي من متطلبات الدراسة بالطبع، سنتبحر في هذا المقرر في صلب القصة نفسها نتكلم عن :
أنواعها الحديثة مرورا بتاريخها ، وبعض نصوص نقدمها للدارسة والتحليل لنفهم القصة عن قرب نقدا فالنقد مفتاح الفهم من خلال الأسئلة والردود، وهنا يتقاطع النقد مع الأدب بقوة وبمرونة فائقة. وعليه فقد استمر تقاطع النقد الأدبي مع باقي العلوم الإنسانية كلما تغيرت الظروف التاريخية والاجتماعية، وتطورت النظرة إلى الأدب. وحينما انبثقت العلوم الحديثة من رحم التجريب والوضعية، كان لابد للنقد أن يجد له مكاناً في هذا العالم، فارتبط بالتاريخ، وحاول تطبيق نظرية التطور الداروينية على النصوص الأدبية، يقول عاد خميس الزهراني:
-يقول كلود ليفي شتراوس، في معنى قريب من هذا: «ظلت العلوم الإنسانية والاجتماعية لقرون تنظر لعالم العلوم الدقيقة والطبيعية كفردوس لا يمكن لها دخوله أبداً. ثم فجأة، فُتح باب صغير بين العالمين، وكانت اللسانيات من فعل ذلك».
أحدثت اللسانيات ثورة في علاقة اللغة بالأدب، وجاء ياكبسون ورفاقه من الشكلانيين الروس، لفك ارتباط الأدب بكل ما لا علاقة له باللغة، وليُعلنوا للعالم كله أن الأدب فن لغوي جمالي قبل أي شيء آخر. وعليه فلا مناص لأي باحث في الأدب من أن يبدأ مهمته من اللغة، ولا شيء غير اللغة، لتبدأ مرحلة حافلة في العلاقة بين النقد الأدبي وعلم اللغة.
في نهاية بيانه الشهير، يستعير ياكبسون مقولة الشاعر الأمريكي جون هولاندر: «يبدو أنه لا وجود لأي سبب لمحاولة فصل الأدب عن القضايا اللسانية عموماً»، ليؤكد أن «لسانياً يصم آذانه عن الوظيفة الشعرية للغة، كما أن عالماً في الأدب غير مبالٍ بالمشاكل اللسانية وغير مطلع على المناهج اللسانية، يعتبران على حد سواء، صورة لمفارقة تاريخية صارخة».
ماذا يعني هذا:
إنه قول مهم :النقد ينقسم إلى قسمين: قسم يتوجه لمتن النص، وقسم لمحتوى النص، وكلاهما مهمان، لأن النص يعالج ظاهرة اجتماعية عموما، والنقد يحاول تقريب الأفهام لما يفكر به الكاتب، أو نقده إن وجده غريبا تائها. وعليه فالقصة حتى تخرج إلينا تمتزج ب:
فكر الكاتب
وجدان الكاتب
مهارة الكاتب
لغة الكاتب
وأخيرا:ماذا يريد أن يقول.
القصة كنظرة عامة
-“القصة القصيرة” أو الأقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، ويكون شخوصها مغمورين وقلما يرقون إلى البطولة والبطولية فهم من قلب الحياة حيث تشكل الحياة اليومية الموضوع الأساسي للقصة القصيرة وليست البطولات والملاحم.
وقد كانت بدايات القصة القصيرة محصورة في الأساطير، والحكايات الأسطورية، والحكايات الشعبية، والحكايات الخرافية، والخرافات، والنوادر التي وجدت بمختلف المجتمعات المحلية القديمة في جميع أنحاء العالم. ووجدت هذه القطع القصيرة غالبًا في شكل شفهي، ونقلت من جيل إلى آخر في شكل شفهي. عثر على عدد كبير من هذه الحكايات في الأدب القديم، من الملاحم الهندية الرامايانا والماهابهاراتا إلى ملاحم هوميروس الإلياذة والأوديسة. وتعتبر ألف ليلة وليلة العربية، والتي جمعت لأول مرة ربما في القرن الثامن، هي أيضا مخزنًا للحكايات الشعبية والقصص الخرافية في الشرق الأوسط.
وهذا مايفسر العلاقة مابين الرواية والقصة فهل يمكننا اعتبار الرواية شكل متطور من القصة؟ حتى دفعتها للوراء وانطلقت للآفاق؟
ومن جهة ثانية فإن القصة القصيرة هي شكل من أشكال الأدب القصصي له طبيعته المستقلة عن الرواية، وقد ظهرت القصة القصيرة بمفهومها الحديث في النصف الأول من القرن التاسع عشر مصاحبة للصحافة التي ساعدت على انتشارها، ثم ازدهرت وبلغت الغاية في القرن العشرين.
لقد ظهر فن القصة القصير في منتصف القرن التاسع عشر في أمريكا وروسيا، ثم ظهر بعد ذلك في انجلترا وفرنسا وغيرها، حتى انتشر وازدهر، وتعددت اتجاهته في القرن العشرين فكثر كتابه، ونقاده،كما عرّفت على أنها نوع فريد وحديث من أنواع الأدب، وعلى الرغم من أنَّ القصص الخيالية القديمة والأساطير، والحكايات، والدعابات لا تحتوي العناصر التي تحدّد القصة القصيرة الحديثة إلا أنّها تشكّل جزءا كبيرا من نشأتها وتطورها عبر الزمن.
-العناصر الأساسية للقصة الحديثة:
-الضبط: المقصود بالضبط في القصة القصيرة هو معرفة الوقت، والمكان الذي تحدثُ فيه أحداثُ القصة، مثل الموقع الجغرافيّ، وحالة الطقس، والزمن أو التاريخ، والوضع الاجتماعي للشخصيات، والمزاج أو الجو العام الموجود في القصة.
-الحبكة: الحبكة هي كيفية تسلسل الأحداث في القصة حتى تبني اللبنة الأساسية للفكرة، وتحتوي القصة القصيرة على حبكة واحدة فقط، ومن عناصرها الأساسية المقدمة، وتسلسل الأحداث من أولها حتى الوصول إلى النتيجة النهائية، أو الفكرة الرئيسية المطروحة في القصة.
- نقطة الصراع: يعتبر هذا العنصر أساسياً لعنصر الحبكة؛ إذ بدونه لا توجدُ حبكة في القصة لأنّها تربط الأحداث ببعضها، وتحرك حبكة القصة كلها، ويوجد عنصران أساسيان لها؛ وهي نقطة الصراع الخارجية التي تشكّل صراع الأحداث خارج الشخصيات، والصراع الداخلي الذي تشعر به الشخصية؛ مثل الصعوبة في اتخاذ قرار، أو مقاومة الرغبة لعمل شيء معيّن، والتغلّب على الألم، وغيرها من الصراعات المتشابهة.
- الشخصيات: المقصود بالشخصيات هنا إمَّا الشخصيات الموجودة في القصة، أو خصائص الشخصية الموجودة في القصة؛ مثل مظهره الخارجي، أو مشاعره ومعتقداته، وأفكاره، أو رأي الآخرين عنه.
-الطول: تتراوح القصة القصيرة عادة بين 1000 و10000 كلمة، ولكن يمكن أن يكون بعضها أطول أو أقصر حسب أسلوب المؤلف وتفضيلاته. ينبغي أن تكون القصة القصيرة قابلة للقراءة في جلسة واحدة، وهي أبرز نقطة في مقال إدغار آلان بو “فلسفة التأليف” “The Philosophy of Composition” عام 1846 ميلادي.
-أدب القصة القصيرة عند العرب
إن هذا الفن من الأدب هو جديد على الأدب العربي إذا نظرنا إليه بالمنظار الفني الاصطلاحي المعاصر، إلا أن القصصَ معروفٌ في تاريخ الحضارة العربية وآدابها منذ العصر الجاهلي مروراً بالعصر الإسلامي؛ فإلى جانب أيام العرب وأخبارهم والحكايات التي كانت تدور على ألسنتهم، جاء القرآن الكريم وقص علينا أخبار الأوائل والقبائل والأمم والأنبياء؛ فحفلت سور البقرة ويوسف ومريم والنمل والكهف وغيرها بقصص شائقة فيها العبر والدروس والأخلاق والدين والعقيدة.
ثم ظهرت الكتب المفردة ذات الاتجاه القصص الوعظي التأملي أو النقدي التهجمي الساخر، من ذلك كتاب (كليلة ودمنة لابن المقفع) في القرن الثاني الهجري، وقد عَرَّبَهُ عن الفارسية التي نقلته بدورها عن الهندية، وكان أغلبه رمزياً على ألسنة الحيوانات.
وقرأنا للجاحظ (كتاب البخلاء)، وهو عبارة عن أقاصيص ونوادر عن أهل الجمع والمنع في القرن الثالث للهجرة، وكذلك الشأن مع بديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع للهجرة في مقاماته الشهيرة، ومع أبي العلاء المعري في (رسالة الغفران) التي أملاها سنة 424 هجرية.
إلا أن العرب لم يعرفوا القصة ولا الرواية على النحو الذي يقصده النقاد المعاصرون اليوم؛ باعتبار القصة تتناول قطاعاً واسعاً من الحياة الإنسانية يمتد فيها الزمن وتتشعب الحوادث وتتعدد الأشخاص، ويعتني فيها الأديب بالتفاصيل والجزئيات؛ فيعطي صورة كاملة لبيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات أو فرد من الأفراد.
وقد حدد عز الدين إسماعيل في كتاب (الأدب وفنونه) ماهية القصة القصيرة وشروطها وفقاً لما قال عنها (إدغار ألان بو) من أنها غالباً ما تتحقق فيها الوحدات الثلاث التي عرفتهاا المسرحية الفرنسية الكلاسيكية، وهي: الحدث الواحد، والوقت الواحد، والشخصية المفردة أو الحادثة المفردة أو العاطفة المفردة.
لقد عرف أدبنا العربي فن القصة القصيرة مترجمة، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأ الكُتَّاب العرب في كتابتها منذ أوائل القرن العشرية، ثم بلغت مرحلة النضج على أيدي أدباء المدرسة الحديثة ومشاهير كتابها، أمثال: محمود تيمور، ومحمود طاهر لاشين، ويحيى حقي، وغيرهم.
ويمكن اعتبار أول قصة قصيرة عربية هي قصة (رمية من غير رامٍ) لسليم البستاني (1847 – 1884 ميلادي) نشرها في مجلة الجنان اللبنانية سنة 1870.
ثم ظهر رواد القصة الحقيقيون أمثال مصطفى لطفي المنفلوطي صاحب (النظرات)، و(العبرات) و(الفضيلة).
وكذلك جبران خليل جبران صاحب (الأرواح المتمردة)، و(الأجنحة المتكسرة)، و(عرائس الموج).
وميخائيل نعيمة في قصصه (كان يا ما كان)، وغيرها.
كما أن البداية الحقيقية لفن الأقصوصة في مصر كانت مع محمد تيمور في (ما تراه العيون).
-القصة القصيرة في الأدب الغربي
تعد القصة القصيرة من أقدم أنواع الأدب في الغرب، وقد وُجِدت على شكل أساطير وحكايات أسطورية وحكايات شعبية وحكايات خرافية وحكايات طويلة وخرافات ونوادر في مختلف المجتمعات القديمة حول العالم. وكما ذكرنا تطورت القصة القصيرة الحديثة في أوائل القرن التاسع عشر.
إن القصة القصيرة في الأدب الغربي هي نتاج التأثيرات القديمة والحديثة، بالإضافة إلى السياقات والتقاليد المحددة لكل أمة أو منطقة أو ثقافة. بعض الموضوعات والأنواع الرئيسة للقصة القصيرة في الأدب الغربي تشمل:
الرومانسية: وهي قصص تصور الحب والعاطفة بين شخصيتين أو أكثر، وغالباً ما تتضمن عناصر المغامرة أو الخيال أو المأساة. أمثلة: “الديكاميرون The Decameron” لجيوفاني بوكاتشيو، “حكايات كانتربري The Canterbury Tales” لجيفري تشوسر، “الليالي العربية The Arabian Nights” لعدد من المؤلفين، “سيدة الكاميليا The Lady of the Camellias” لألكسندر دوماس الابن، “هدية المجوس The Gift of the Magi” لأو. هنري.
القوطية: وهي القصص التي تثير الرعب والخوف والتشويق، وغالباً ما تتضمن عناصر خارقة للطبيعة أو غامضة أو بشعة. أمثلة: “قلعة أوترانتو The Castle of Otranto” بقلم هوراس وولبول، “سقوط بيت آشر The Fall of the House of Usher” لإدغار آلان بو، “فرانكنشتاين Frankenstein” لماري شيلي، “دراكولا Dracula” لبرام ستوكر، “دورة المسمار The Turn of the Screw” لهنري جيمس.
الواقعية: وهي قصص تصور الحياة اليومية ومشاكل الأشخاص العاديين، وغالباً ما تكون مصحوبة بتعليقات نقدية أو اجتماعية. أمثلة: “المعطف The Overcoat” لنيكولاي غوغول، “مدام بوفاري Madame Bovary” لغوستاف فلوبير، “القلادة The Necklace” لغي دي موباسان، “موت إيفان إيليتش The Death of Ivan Ilyich” لليو تولستوي، “التحول The Metamorphosis” لفرانز كافكا.
الحداثة: وهي قصص تجرب أشكالاً وتقنيات ووجهات نظر جديدة، وغالباً ما تتحدى أعراف وتوقعات السرد التقليدي. أمثلة: “حديقة الطرق المتفرعة The Garden of Forking Paths” لخورخي لويس بورخيس، “الموتى The Dead” لجيمس جويس، “ثلوج كليمنجارو The Snows of Kilimanjaro” لإرنست همنغواي، “اليانصيب The Lottery” لشيرلي جاكسون، “ورق الحائط الأصفر The Yellow Wallpaper” لشارلوت بيركنز غيلمان.
الغربية: وهي قصص تصور حياة ومغامرات الحدود الأميركية، وغالباً ما تُظْهِر رعاة البقر والخارجين عن القانون والهنود والمستوطنين. أمثلة: “The Luck of Roaring Camp” بقلم بريت هارت، و”The Virginian” بقلم أوين ويستر، و”Riders of the Purple Sage” بقلم زين غراي، و”The Red Pony” بقلم جون ستاينبيك، و”Brokeback Mountain” بقلم آني برولكس.
أمثلة عن القصص القصيرة الغربية
ثمة العديد من الأمثلة عن القصص القصيرة التي حققت شهرة وشعبية أدبية.
بعض القصص القصيرة الكلاسيكية هي:
1 -هدية المجوس (The Gift of the Magi) بقلم أو. هنري: قصة مؤثرة لزوجين شابين يضحيان بأغلى ممتلكاتهما لشراء هدايا عيد الميلاد لبعضهما.
2 -القلادة (The Necklace) بقلم غي دو موباسان: قصة مأساوية لامرأة تستعير عقداً من الألماس من صديق وتفقده، لتكتشف بعد سنوات أنه مزيف.
-اليانصيب (The Lottery) بقلم شيرلي جاكسون: قصة صادمة لبلدة صغيرة تقيم طقوساً سنوية لسحب القرعة لاختيار ضحية لتضحية عنيفة.
-القلب الواشي (The Tell-Tale Heart) بقلم إدغار آلان بو: قصة رعب لرجل يقتل مالك منزله القديم ويطارده صوت قلبه النابض.
-ورق الحائط الأصفر (The Yellow Wallpaper) بقلم شارلوت بيركنز جيلمان: قصة نفسية لامرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة وتصبح مهووسة بنمط ورق الحائط في غرفتها.
-القصة والنقد
يقول رشيد الخديري:
-إن الأدب يتطوّر بتطوُّر النقد، ذلك بـ "أن الأدب يتعذَّر أن يستشرف آفاقا جديدة من دون حركة نقدية تواكبه وتستقصي دلالاته وأبعاده وتثمن اقتراحاته الجمالية"، ونقصد بالنقد ها هنا تلك الممارسة المنهجية والإجرائية التي تروم قراءةَ النص الأدبي قراءة ناجزةً ودقيقةً، انطلاقًا من خلفيات نظرية ومعرفية يستند إليها ويسترشد بها كل دارسٍ للأدب.
هذا قول حق فلا تطور دون نقد لوضع أصابع الملاحظات على الهنة في النص، ومن أغلق أذنيه وعقله فقد تراجع وقبع في الظلمة ردحا طويلا .
ويقول :
-ومن المسلّم به في مجال النقد والنظريات الأدبية أن نتصوَّر إمكانية الوصول إلى فعلٍ نقدي منتج وفعَّال، ما لم يكن مُتَّصِلًا بشروط إنتاجه وسياقات بنائه، وقادرًا على إعادة التفكير في الأدب وتعميق النقاش حوله وتجديد آليات البحث والتَّقصي والمساءلة، حيث إنه "لا يُمكن للأداة النقدية أن تستجيب للطموحات ما لم تكن في دورها خاضعة لبوصلة واضحة، ولصرامة نظرية تضع الاستراتيجيات وتحدد الثوابت والمنطلقات". وهذه المسلَّمة تفرض البحث الدائم، المتحفِّز، الوثَّاب في عوالم التنظير النقدي واستشراف آفاق أوسع وأرحب، حتى يكون التفكير في الأدب من جهة، وفي المرجعيات النظرية لكل خطابٍ نقدي من جهة أخرى، تفكيرًا عميقًا، ملتحمًا مع تحولات الممارسة النقدية العربية بحثًا وتنظيرًا وأجرأةً، وما يعنيه هذا الالتحام من قدرة على الإنصات الجيد لنبض النصوص في علاقتها الجدلية مع خصوصية كل منهج نقدي "بعيدًا عن الإسقاطات المفاهيمية الجاهزة، والتي من شأنها خنق النص ومحاصرته بترسانته النظرية.
وكما يتطور الأديب ونصه الأدبي، يتطور الأدب منطلقا من استيعاب الطرف المقابل لنتاجه وإخلاصه في نقده الموضوعي.
-الفرق بين القصة القصيرة والرواية:
-يظهر الفرق بين القصة القصيرة والرواية جلياً حيث إنّ القصة القصيرة تتناول قطاعاً عرضياً في الأحداث، بينما تناول الرواية قطاعاً طولياً من الحياة أمّا من حيث الزمان فإن الرواية تتوغل بشكل كبير في أبعاد الزمان، ولكنّ القصة القصيرة أقرب إلى التوغل في أبعاد النفس من التوغل في أبعاد الزمان.
**************
من أسباب تراجع مكانة القصة القصيرة:يقول د.محمد القيعي:
-أتى على القصة القصيرة حين من الدهر «الربع الثانى من القرن العشرين»، كانت أكثر الأنواع الأدبية رواجا، وكانت الفن الأكثر إغراء كتابة وقراءة، وقديما أثر عن الروائى هنرى جيمس قوله : «القصة القصيرة وليس الرواية الأكثر ملاءمة لوصف حياة القرن العشرين التى تتميز بالهشاشة وسرعة التقلب والتلاشي» .
بعدها تم التبشير بعصر الرواية، وتم الاحتفاء بها عربيا وعالميا، وخصصت لها الجوائز الكبري، وأقيمت لها الاحتفالات العظمي، فتوارت القصة القصيرة جانبا ولو إلى حين. نستطلع آراء عدد من الكتاب والنقاد والناشرين عن واقع القصة القصيرة، كيف تبدو؟ ما مستقبلها؟ كيف السبيل للتجديد فيها والإضافة إليها ؟
-ومن الأسباب الأخرى أن المسابقات والجوائز لم تحتفي بأصحاب القيم بقدر احتفائها بكتاب العصر الحديث وتسويق القيم الجديدة حتى لوانسلخت عن قيمنا، مما أدى إلى إهمال كم كبير من الكتاب الذين يحافظون على قيمنا النبيلة.وعليه فبقي الإعلام هو من يحكم ويسوق حتى لو كان المضمون معوج.
وتقول الأديبة فاطمة المزروعي:
-الرواية هي الأدب الأكثر شيوعا والأكثر بساطة وسهولة ويستطيع أن يصل إلى أكبر عدد من القراء اليوم.
ويقول د.عبد الله إبراهيم:
- القصة القصيرة ميتة مجازيا وثقافيا وقد سلمت الراية لفن الرواية.ومن الاستحالة على القصة القصيرة الارتقاء إلى رتبة النوع القابل لتحولات حقيقية في بنيته ووظيفته الدلالية.وقال إن القصة القصيرة ما زالت أسيرة أصلها الحكائي وشكلها المغلق في عصر أصبح كل شيء فيه مفتوحا، ومحاولة الانفتاح فيها ستجعل منها مشهدا سرديا في نص روائي.
هل ماورد عن الدكتور صحيح؟ لو سلمنا بهذا فسوف نتساءل: هل يمكن للقصة أن تصبح رواية؟ فإن كان نعم..فهذا يعني تحول الأديب للرواية أمر منطقي جدا.
ومع الرواج النقدي والجماهيري لفن الرواية في العالم العربي في السنوات الأخيرة تراجعت القصة القصيرة لدرجة أن نقادا عربا حذروا من أن يختفي فن القصة ليلحق بفن المقال والنصوص المسرحية التي كان كتابها يحظون بمكانة كبيرة في الستينيات ولا يقلون شهرة عن المخرجين والممثلين المشاركين في العروض· لكن الكاتب المغربي محمد اشويكة رأى أن القصة القصيرة في بلاده بخلاف الحال في معظم الدول العربية تشهد حاليا انتعاشا ملحوظا يتضمن ثراء في المغامرات الفكرية والفنية· وقال إن القصة أصبحت في صدارة المشهد الثقافي بالمغرب وكشفت عن مغامرات إبداعية مهمة لكتاب لا وهم لديهم خارج الكتابة نفسها يؤمنون بأن القصة لحظة وجودية للقبض على القول الإنساني والقصة المغربية الجديدة تنتصر للكتابة أولا بما تحمله من أفكار وجماليات·
خاتمة
باختصار: القصة موجودة شئنا أم أبينا ويجسد حضورها كالتالي:
1- كجزء من السرد الروائي.
2- كمادة إعلامية موظفة.
3- كمادة أدبية مدرسية.
4- وكاهتمام أدبي خاص.
وبكل الأحوال ولأن الرواية استطاعت احتلال مكانة مميزة على الشاشة واستحوذت عى اهتمام النقاد والأدباء، فقد تفردت في حضورها القوي منذ زمن غير بعيد. ولكن عموما يبقى السؤال:
-هل كل من يكتب القصة قادر على كتابة الرواية والعكس؟ أم هو اختصاص غير متعد لغير؟
التعديل الأخير تم بواسطة ثريا نبوي ; 12-03-2024 الساعة 03:08 AM
سبب آخر: تعديل العنوان الدوار
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »